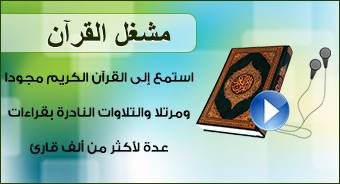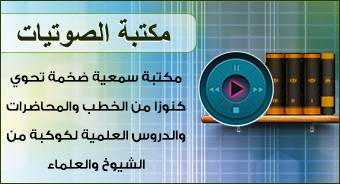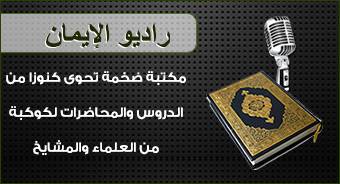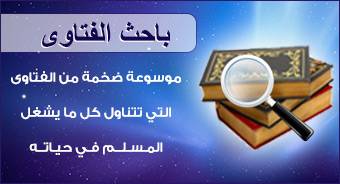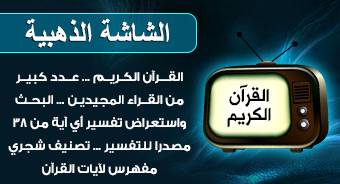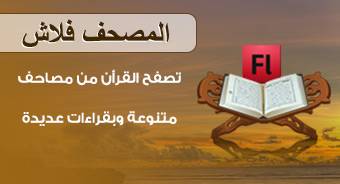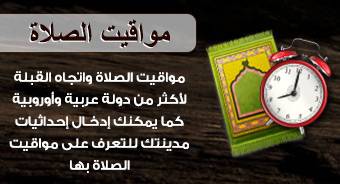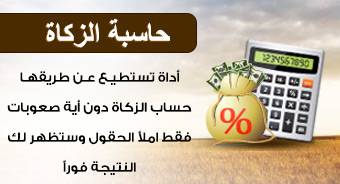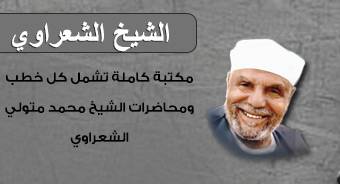.النوع الرابع فيما يحتاج إلى وصفه من الطيور:
.النوع الرابع فيما يحتاج إلى وصفه من الطيور:
ويحتاج الكاتب إلى ذلك في رسائل الصيد، وإهداء الجوارح، والجواب عو إهدائها، وكتابة قدم البندق، وما يجري مجرى ذلك؛ وهو على أربعة أصناف:الصنف الأول: الجوارح:وهي يصاد بها الطير والوحش؛ ويحتاج الكاتب إلى وصفها في الرسائل الصيدية وفي إهداء شيء من الجوارح أو الجواب عنها.واعلم أن الصائد الكبير الجثة المعتبر في الصيد في جميع أجناس الجوارح هي الإناث؛ أما ذكورها فإنها ألطف في المقدار وأضعف في الصيد على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.قال في التعريف: ويستحب في الجوارح كبر هامتها، ونتو صدرها، واتساع حماليقها، وقوة إبصارها، وحدة مناسرها، وصفاء ألوانها، ونعومة رياشها، وقوة قوادمها، وتكاثف خوافيها، وثقل محملها، وخفة وثباتها، واشتدادها في الطلب، ونهمها في الأكل؛ وقد قسمها في التعريف إلى قسمين: صقور وبزارة، وفرق بينهما بأن الصقر ما كان أسود العين، والبازي ما كان أصفر العين على اختلاق المسميات، ثم قال: أما العقاب فإنه لا يعد في الصقور ولا في البزاة وهو معدود في الجوارح، وفي الطير الجليل. وبالجملة فالجوارح على ثلاثة أقسام:القسم الأول العقاب؛ وهو ضربان:الضرب الأول المخصوص باسم العقاب:وهو مؤنثة لا تذكر، وتجمع على عقبان وأعقب.قال في المصايد والمطارد: وهي من أعظم الجوارح، وليس بعد النسر في الطير أعظم منها، وأصل لونها السواد.فمنها: سوداء دجوجية، وخدارية؛ وهي التي لا بياض فيها.ومنها: البقعاء؛ وهي التي يخالط سوادها بياض.ومنها: الشقراء؛ وهي التي في رأسها نقط بياض. قال أبو عبيدة ويونس: ويقال لذكر العقاب الغرن- بفتح الغين والراء المهملة- ويقال: إن ذكور العقبان من طير آخر لطاف الجرم لا تساوي شيئاً، تلعب بها الصبيان. والعقاب من أسرع الطير طيراناً؛ فقد حكي أن عقاباً حملت كف عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد المسمى بيعسوب قريش المقتول يوم الجمل بالكوفة؛ فألقتها بمكة فأخذت فوجد بها حلقة فعرف أنها كفه؛ وأرخ ذلك الوقت فتبين أنها ألقتها يوم الجمل الذي قتل فيه.وأول من صادها أهل المغرب؛ فلما نظرت الروم إلى شدة أمرها وأفراط سلاحها قال حكماؤهم: هذا لا يفي خيره بشره.وصفة الوثيق النجيب منها: وثاقة الخلق، وثبوت الأركان، وحمرة اللون، وغؤور العين بالحماليق؛ وأن تكون صقعاء، عجزاء لا سيما ما كان منها من أرض سرت أو جبال المغرب. وهي تصيد الظباء والثعالب والأرانب، وقد تصيد حمر الوحش؛ وطريق صيدها إياها أنها إذا نظرت حمار الوحش رمت بنفسها في الماء حتى يبتل جناحاها ثم تخرج فتقع على التراب فتحمل منه ومن الرمل ما يعلق بهما، ثم تطير طيراناً ثقيلاً حتى تقع على هامته فتصفق علىعينيه بجناحيها فيمتلئان تراباً من ذلك التراب الذي علق بجناحيها، فلا تستطيع المسير بعد ذلك فيدركها القانص فيأخذها، وربما كسرت الآدمي.ومما يحكى في ذلك: أن قيصر ملك الروم أهدى إلى كسرى ملك الفرس عقاباً، وكتب إليه: إنها تعمل أكثر من عمل الصقور؛ فأمر بها كسرى فأرسلت على ظبي فاقتنصته، فأعجبه ما رأى منها فانصرف وجوعها ليصيد بها فوثبت على صبي له فقتله؛ فقال كسرى: إن قيصر قد جعل بيننا وبينه دماً ثائراً بغير جيش، ثم إن كسرى أهدى إلى قيصر نمراً وكتب إليه: أن قد بعثت إليك فهدأ يقتل الظباء وأمثالها من الوحش، وكتم ما صنعت العقاب، فأعجب قيصر حسن النمر ووافق صفته ما وصف من الفهد، وغفل عنه فافترس بعض فتيانه فقال: صادنا كسرى.ومن شأنها: أنها لا تطلب شيئاً من الوحش الذي تصيده؛ وهي لا تقرب إنساناً أبداً خوفاً من أن يطلب صيدها، ولا تزال مرقبة على مرقب عال؛ فإذا رأت بعض سباع الطير قد صاد شيئاً انقضت عليه، فإذا أبصرها هرب وترك الصيد لها؛ فإن جاعت لم يمتنع عليها الذئب في صيدها، وربما اغتالت البزاة فقتلتها.ومن خصائصها: أنها أشد إخفاء من سائر الطير.قال غطريف بن قدامة الغساني صاحب صيد هشام بن عبد الملك: وأول من لعب بالعقاب أهل المغرب؛ فلما عرفوا أسرارها نفذوها إلى ملك الروم فاستدعى جميع حكمائه فقال لهم: انظروا في قوة هذا الطير وعظم سلاحه، كيف تجب تربيته، وتعرفوا أسراره في صيده وتعليمه، وكيف ينبغي أن يكون؟ فأجابوا جميعاً: بأن هذا الطائر دون سائر أجناسه كالأسد في سائر الوحوش، وكما أن الأسد ملك كذلك هذا ملك بين سائر سباع الطير. وعند العداوة والغضب كل الأجناس عنده من سائر الحيوان على اختلاف أنواعه واحد لقوة غضبه وشدة بأسه، فهو لا يستعظم الآدمي ولا غيره من الحيوان.الضرب الثاني- الزمج:بضم الزاي وفتح الميم المشددة ثم جيم والعامة تبدل الزاري جيماً والجيم زاياً، وهو طائر معروف تصيد به الملوك الوحش، وأهل البيزرة يعدونه من خفاف الطير الجوارح، إلا أنهم يصفونه بالغدر وقلة الإلف لكثافة طبعه وكونه لا يقبل التعليم إلا بعد بطء ومن عادته أنه يصيد على وجه الأرض؛ وأحسن صفاته أن يكون أحمر اللون.وقال الليث: الزمج طائر دون العقاب حمرته غالبة، والعجم تسميه دوبرا دران، ومعناه أنه إن عجز عن الصيد أعانه عليه أخوه.القسم الثاني من الجوارح: البزاة:وهي ما اصفرت عينه، وهي على خمسة أضرب:الأول البازي- المختص في زماننا باسم البازي؛ وفي ضبطه ثلاث لغات أفصحها بازي بكسر الزاي وتخفيف الياء في الآخر، والثاني باز بغير ياء في آخره، والثالث بازي باثبات الياء وتشديدها حكاها ابن سيده؛ ويقال في التثنية: بازيان، وفي الجمع: بواز وبزاة، ولفظه مشتق من البزوان، وهو الوثب. وهو خفيف الجناح، سريع الطيران، وهو من أشرف الطيور الجوارح وأحرصها على طلب صيده.ففي أخبار نصر بن سيار أن بعض كبراء الدهاقين غدا عليه بطبر ستان ومعه منديل فيه شي ملفف، فكشف عنه بين يديه فإذا فيه شلو بازٍ ودراجة، فأطلقه عليها فأحست به وكنت قد أمرت بإحراق قصب قد أفسد أرضاً لي- فتحاملت الدراجة حتى اقتحمت النار هاربة من البازي، واشتد طلبه لها وحرصه عليها فلم ترده النار عنها واقتحمها في أثرها، فأسرعت فيهما، فأدركهما وقد احترقا، فأحضرهما إلى الأمير ليراهما فيرى بهما ثمرة إفراط الحرص وإفراط الجبن، وهو من أشد الحيوان كبراً وأضيقها خلقاً.قال القزويني: ولا يكون إلا أنثى، وذكرها نوع آخر من حدأة أو شاهينٍ أو غيرهما؛ ولذلك تختلف أشكالها. والبازي قليل الصبر على العطش، ومأواه مساقط الشجر.ومن فضيلته: أن الصيد فيه طبيعة لأنه يؤخذ من وكره فرخاً من غير أن يكون يصيد مع أبويه، فيصيد ابتداءً وقريحة من غير تضرية، بخلاف الصقر فإنه إذا أخذ قبل أن يتصيد مع أبويه لم ينجب ولم يصدن وإذا كان قد لحق أبويه وصاد معهما ثم عود أكثر مما يوجد عنده في تلك الحال وجريء على ما هو أكبر من الظباء اعتاد ذلك ومهر فيه.قال صاحب المصايد والمطارد: وعدد ريش جناح البازي عشرون ريشة: أربع قوادم، وأربع مناكب، وأربع أبا هر، وأربع كلى، وأربع خوافٍ، ويقال: سبع قوادم وسبع خواف، وسائره لغب. والخوافي أخف من القوادم.والمستحب من صفاته: صغر المنسر، والرأس، وغلظ العنق، وسعة اللحيين، ودائرتي الأذنين والشدقين، وسعة الحدقة، وطول القوادم، وقصر الخوافي والذنب، وشدة اللحم، وعرض ما بين المنكبين والزور، وسعة الحوصلاء، وسعة ما ينتقل إليه طعمه، وعرض المخالف، ورزانة المحمل، وغلظ خطوط الصدر، وذكاء القلب، ولا تشمير، وكثرة الأكل، وتتابع النهش، وسرعة الاستمراء، وشدة الانتفاض، وضخامة السلاح، وبعد الذرق. وأن تراه كأنه مقعياً إذا استقبلته على يد حامله، تشبيهاً بالغراب الأبقع.قال صاحب المصايد والمطارد: والمختار من ألوانها الأحمر الأكثر سواداً، الغليظ خطوط الصدر، والأشهب الشديد الشهبة، الشبيه بالأبيض، والأصفر المدبج الظهر، قال: وسواد لسانه أدل على نجابته.والبازي يصيد الكلب، والأرنب، والغزال، والكركي وما في معناه، والدراج والحجل، وسائر الحمام، والبط، وسائر طيور الماء.ومن محاسن البازي: عدم الإباق، فإنه إن صاد بقي على فريسته، وإن لم يصد وقف مكانه فلا يحتاج إلى كد ولا تعب ولا طرد خيل.وأول من صاده من الملوك قسطنطين ملك الروم؛ وذلك أنه مر يوماً بلحف جبل فرأى بازيا يطير ثم نزل على شجرة كثيرة الأغصان كبيرة الشوك، فأعجبته صورته، وراقه حسن لباسه؛ فأمر بأن يصاد له جملة من البزاة فصيدت له وحملت إليه فارتبطها في مجلسه، فعرض لبعضها في بعض الأيام أيم فوثب عليه فقتله، فقال هذا ملك يغضبه ما يغضب الملوك فنصب له بين يديه كندرة، وكان هناك ثعلب داجن، وهو الذي يربى في البيوت، فوثب عليه فما أفلت إلا جريحاً، فقال: هذا ملك جبار لا يحتمل ضيماً، ثم مر به طائر فكسره ونهش منه؛ فقال: هذا ملك نوعه لما جاع أخذ طعامه بسلطان وقدرة، فحمله على يده وصاد به.الثاني الزرق بضم الزاري المعجمة وتشديد الراء المهملة المفتوحة وقاف في الآخر وهو ذكر البازي.قال في المصايد والمطارد: وهو يصيد ما يصيد البازي من دق الطير ولا ينتهي إلى صيد الكركي.الثالث الفقيمي وهو باز قضيف قليل الصيد ذاهل النفس.الرابع الباشق بكسر الشين وفتحها فارسي معرب وهو طائر لطيف وصفاته المحمودة كصفات البازي المحمودة؛ وأفضلها أثقلها وزناً.قال في المصايد والمطارد: وهو يصيد العصافير وما قاربها. وقال في حياة الحيوان: إنه يصيد أفخر ما يصيده البازي، وهو الدراح والحمام والورشان، وإذا قوي على صيده لا يتركه إلا أن يتلف أحدهما.الخامس البيدق- وهو دون الباشق، وصيده العصافير.القسم الثالث من الجوارح الصقور- وهي السود العيون من الجوارح وهي ضربان:الضرب الأول: الشواهين:أحدها شاهين وهي صنفان؛ الأول المشتهر باسم الشاهين، وقد ذكر العلماء بالجوارح: أن الشواهين هي أسرع الجوارح كلها وأشجعها وأخفها وأحسنها تقلباً، وإقبالاً وإدباراً، وأشدها ضراوةً على الصيد؛ إلا أنهم عأبوها بالإباق وما يعتر بها من شدة الحرص، حتى إنها ربما ضربت نفسها على الغلظ من الأرض فماتت، وهي أصلب عظاماً من غيرها من سائر الجوارح؛ ويقال: إن صدرها عصب مجول ملحم، ولذلك تجدها تضرب بصدرها ثم تعلق بكفها، وهم يحمدون منها ما قرنص داجناً دون ما قرنص وحشياً.ومن كلام بعضهم: الشاهين كاسمه يعني كالميزان المسمى بالشاهين فإنها لا تحمل أيسر حال من الشبع ولا أيسر حال من الجوع؛ بل حالها معتدل كاعتدال الميزان؛ ويقال: إن الحمام يخافها أكثر مما يخاف غيرها من الصقور.ثم المختار من صفاتها فيما ذكره صاحب المصايد والمطارد: الأحمر اللون إذا كان عظيم الهامة، واسع العينين حادهما، سائل السفعتين، تام المنسر، طويل العنق، رحب الصدر، ممتليء الزور، عريض الوسط، جليل الفخذين، قصير الساقين، قريب العقدة من القفا، طويل الجناحين، قصير الذنب، سبط الكف، غليظ دائرة الخصر، قليل الريش لينه، تام الخوافي، ممتليء العكوة، رقيق الذنب، إذا صلب عليه جناحيه لم يفضل عنهما شيء من ذنبه.قال صاحب المصايد والمطارد: وأهل الإسكندرية يزعمون أن السود منها هي المحمودة، وأن السواد هو أصل لونها وإنما انقلبت إلى لون البراري فحالت؛ قال: والحمر منها تكون في الأرياف والمواضع السهلة؛ والشهب في الجبال والبراري، ثم قال: ولا يصيد منها الكركي والحبرج إلا البحرية.وأول من صادها فيما يقال قسطنطين ملك الروم أيضاً، وذلك أنه رأى شاهيناً محلقا على طير الماء يصطاده فأعجبه ما عاين من فراهته وسرعة طيرانه وحسن صيده؛ فإنه رآه يحلق في طيرانه حتى يلحق بعنان الجو ثم يعود في طرفه عني فيضرب طير الماء فيأخذه قناصاً، فقال: ينبغي أن يصاد هذا الطائر ويعلمن فإن كان قابلاً للتعليم ظهر منه أعجوبة في أمر الصيد، فأمر بصيده وتعليمه، فصيد وعلم وحمله على يده.قال في المصايد والمطارد وإنه كان من رتبة ملوك الروم أنه إذا ركب سارت الشواهين حائمة على رأس الملك حتى ينزل فتقع حوله إلى أن ركب بها ملك منهم، وسار وهي على رأسه، فطار طائر فانقض بعض تلك الشواهين عليه فاقتنصه، وأعجب الملك به فضراها على الصيد وصاد بها.وقال ابن غفير: كانت ملوك العرب إذا ركبت في مواكبها طيروا الشواهين فوق رؤوسهم، وكان ذلك عندهم هو الرتبة العظيمة.الثاني من الشواهين: الأنيوه، قال في المصايد والمطارد: وهو دون الشاهين في القوة، وله سرعة لا تزيد على صيد العصافير.الضرب الثاني: من الصقور ما عدا الشواهين:وهي أصناف: الأول السنقر قال في التعريف: وهو أشرف الجوارح وإن كان لا ذكر له في القديم. قال: والسناقر تجلب من البحر الشامي مغالي في أثمانها؛ ثم قال: وكان الواحد منها يبلغ ألف دينار، ثم نزل عن تلك الرتبة، وانحط عن تلك الهضبة.الثاني المخصوص في زماننا باسم الصقر، ويجمع على أصقر وصقور وصقورة، قال في التعريف: والعرب تسمي هذا النوع الحر؛ ويقال له: الأكدر، والأجدل.قال في المصايد والمطارد: ويقال لها: بغل الطير، لأنها أصبر على الأذى، وأحمل لغليظ الغذاء، وأحسن إلفاً، وأشد إقداماً على جلة الطير، ومزاجه أبرد من البازي والشاهين.وبسبب ذلك يضرى على الغزال والأرنب ولا يضرى على الطير لأنه يفوته، وهو أهدى من البازي نفساً، وأسرع استئناساً بالناس، وأكثرها قنعاً، وأبرد مزاجاً، لا يشرب ماء وإن أقام دهراً؛ ونوعه يوصف بالبخر ونتن الفم، ومسكنه المغائر والكهوف وصدوع الجبال دون رؤوس الأشجار وأعالي الجبال.والعرب تحمد من الصقور ما قرنص وحشياً، وتذم ما قرنص داجناً، وتقول: إنه يتبلد ولا يكاد يفلح. وهي تصيد الكركي وما في معناه، والبط وسائر طير الماء.والصقور من أثبت الجوارح جناناً في الطيران، وأحرصها في اتباع الصيد، حتى يحكى أن بعض ملوك مصر أرسل صقراً على كركي صبيحة يوم الجمعة بمصر، فبينما الناس يصلون الجمعة بدمشق إذا وقع هو والكركي بالجامع الأموي بدمشق، فأخذ فوجد فيه لوح السلطان فعرف به؛ فكتب نائب الشام إلى السلطان يخبره وأرسله ِإليه هو وصيده.قال في المصايد والمطارد: ومن ألوان الصقر كونه أحمرن وأبعث، وأحوى، وأبيض، وأخرج، وهو الذي فيه نقط بيض. قال: ويستحب في الصقر أن يكون أحمر اللون، عظيم الهامة، واسع العينين، تام المنسر، طويل العنق، رحب الصدر، ممتلئ الزور، عريض الوسط، جليل الفخذين، قصير الساقين، قريب القعدة من القفا، طويل الجناحين، قصير الذنب، سبط الكف، غليظ الأصابع فيروزجها، أسود اللسان. قال: وتجمع هذه الصفات الفراهة والوثاقة والسرعة.قال أدهم بن محرز: وأول من لعب بالصقر الحارث بن معاوية بن كندة الكندي، خرج يوماً إلى الصيد فرأى صيادين قد نصبوا شباكاً عدة، فوقع فيها عصافير عدة، فحين رآها صقر من الجو انقض عليها يطلبها، فأمر الحارث بنصب الشباك للصقور فنصبت لها فاصطاد منها جملة. ويقال: إن صيد الصقر غير طبيعي لهح وإنما يستفيد ذلك بالتعليم، بدليل أن فراخ الباز إذا أخذت من العش وعلمت اصطادت أجود صيد لأن صيدها طبيعي، بخلاف الصقر فإنه إذا أخذ من الوكر ثم كبر فإنهلا يصطاد غير طعمه فلذلك ينهى عن تربية الصقر.الثالث الكونج- قال في حياة الحيوان: نسبته من الصقور كنسبة الزرق إلى البازي إلا أنه أحر منه، ولذلك كان أخف جناحاً وأقل بخراً. قال: ويصيد أشياء من طير الماء ويعجز عن الغزال لصغره.الرابع الكوهية- وهي موشاة بالبياض والسواد يخالط لونها صفرة.وقال في التعريف: وتجلب من البحر.الخامس السقاوة- وهي قريبة الشكل من الصقر.السادس اليؤيؤ- بضم الياء المثناة تحت وهمزة بعدها وضم الثانية وهمزة بعدها أيضاً.قال في المصايد والمطارد: وتسميه أهل مصر والشام الجلم وبهذا سماه في التعريف؛ وهو طائر صغير أسود اللون يضرب للزرقة، وهي مع صغرها يجتمع الاثنان منها على الكركي فيصيدانه، وسموه الجلم أخذاً من الجلم؛ وهو المقص تشبيها به لأن له سرعة كسرعة المقص في قطعه؛ ومزاجه بالنسبة إلى الباشق بارد رطب لأنه أصبر نفساً منه، وأثقل حركة. وهو يشرب الماء شرباً ضرورياً كما يشربه الباشق؛ ومزاجه بالنسب إلى الصقر حار يابس ولذلك هو أشجع منه. ويقال: إن أول من ضراه على الصيد واصطاد به بهرام جور- أحد ملوك الفرس- وذلك أنه رأى يويؤاً يطارد قنبرة، ويراوغها، ويرتفع معها ثم لم يتركها حتى صادها؛ فأمر بتأديبه والصيد به.الصنف الثاني: الطير الجليل:وهو المعبر عنه بطير الواجب، وبه تعتني رماة البندق ونحوها، تفتخر بإصابته وصرعه، ويحتاج إليه في الرسائل الصيدية، وفي كتابة قدم البندق ونحوها، وهو أربعة عشر طائراً؛ وهي على ضربين:الضرب الأول طيور الشتاء:وهي التي يكثؤ وجدانها فيه، وهي عشرة طيور: الأول الكركي- وهو طائر أغبر، طويل الساقين، في قدر الإوزة، ويجمع على كراكي؛ وفي طبعه خور يحمله على التحارس، حتى إنه إذا اجتمع جماعة من الكراكي لا بد لها من حارس يحرسها بالنوبة بينها. ومن شأن الذي يحرس منها أن يهتف بصوت خفي كأنه ينذر بأنه حارس، فإذا قضى نوبته، قام واحد ممن كان نائماً يحرس مكانه حتى يقضي كل منها نوبته من الحراسة، ولا تطير متفرقة بل صفاً واحداً، يقدمها واحد منها كالرئيس لها وهي تتبعه، يكون ذلك حيناً ثم يخلفه آخر منها مقدماً حتى يصير الذي كان مقدماً مؤخراً؛ وفي طبعها التناصر والتعاضد. ومن خاصتها أن أنثاها لا تقعد للسفاد بل يسفدها وهي قائمة، ويكون سفاده سريعاً كالعصفور.وذكر جميع بن عمير التميمي أن الكراكي تبيض في السماء، ولا تقع فراخها؛ وكذبه المحدثون في ذلك وإن كان قد روى عنه أهل السنن.قال القزويني في عجائب المخلوقات: والكركي لا يمشي على الأرض إلا بإحدى رجليه ويعلق الأخرى، وإن وضعها وضعاً خفيفاً مخافة أن تخسف به الأرض.قال في المصايد والمطارد: وهو من أبعد الطير صوتاً يسمع على أميال.قال: وإذا تقدم مجيئها في الفصل استدل بذلك على قوة الشتاء. ويقال: إن الكراكي تأتي إلى مصر من بلاد الترك. وفي طلبه وصيده تتغالى ملوك مصر تغالياً لا يدرك حده، وتنفق في ذلك الموال الجمة التي لا نهاية لها، وكان لهم من علو الشأن بذلك مالا يكون لغيرهم. وأكله حلال بلا نزاع.الثاني الإوز- بكسر الهمزة وفتح الواو واحدته إوزة وجمعوه على إوزون، والمراد هنا الإوز المعروف بالتركي، وهو: طير في قدر الإوز البلدي أبيض اللون. وله تبختر في مشيته كالحجل. وهو من جملة طير الماء مقطوع بحل أكله.الثالث اللغلغ وهو دون الإوز في المقدار، لونه كلون الإوز الحبشي إلى السواد، أبيض الجفن، أصفر العين، ويعرف في مصر بالعراقي، ويأتي إليها في مبادئ طلوع زرعها في زمن إتيان الكراكي إليها؛ ومن شأنها أن يتقدمها واحد منها كالدليل لها، ثم قد تكون صفاً واحداً ممتداً كالحبل، ودليلها في وسطها متقدم عليها بعض التقدم؛ وقد يصف خلفه صفين ممتدين يلقيانه في زاوية حادة حتى يصير كأنه حرف جيم بلا عراقة، متساوية الطرفين؛ ومن خاصتها أنها إذا كبرت حدث في بياض بطونها وصدورها نقط سود، والفرخ منها لا يعتريه ذلك.الرابع الحبرج- بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة وضم الراء المهملة وجيم في الآخر- وهو الحبارى.قال في المصايد والمطارد: ويقع على الذكر والأنثى ويجمع على حباريات؛ وذكر غيره أن واحده وجمعه سواء، وبعضهم يقول: إن الحبرج هو ذكر الحباري.قال في المصايد والمطارد: وهو طائر في قدر الديك كثير الريش، ويقال لها: دجاجة البر.قال في حياة الحيوان: وهي طائر طويل العنق، رمادي اللون، في منقاره بعض طول؛ يقال لذكر الحباري: الخرب بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وباء موحدة في الآخر ويجمع على خراب وأخراب وخربان.ومن خاصته: أن الجارح إذا اعتنقها أرسلت عليه ذرقاً حاصلاً معها متى أحبت أرسلته فيه حدة تمعط ريشه، ولذلك يقال: سلاحها سلاحها.قال في حياة الحيوان: وهي من أشد الطير طيراناً، وأبعدها شوطاً، فإنها تصاد بالبصرة فيوجد في حواصلها الحبة الخضراء التي شجرها البطم، ومنابتها تخوم بلاد الشام، وإذا نتف ريشها وأبطأ نباته ماتت كمداً؛ قال: وهي من أكثر الطير جهداً في تحصل الرزق، ومع ذلك تموت جوعاً بهذا السبب.قال في المصايد والمطارد: وهي مما يعاف لأنها تأكل كل شيء حتى الخنافس؛ وقال في حياة الحيوان: حكمها الحل لأنها من الطيبات؛ واستشهد له بحديث الترمذي من رواية سفينة مولى رسول الله أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبارى ويقال لولدها: اليحبور، وربما قيل له: نهار، كما يقال لولد الكروان: ليل.الخامس التم- بفتح التاء وتشديد الميم- وهو طائر في قدر الإوز أبيض اللون، طويل العنق، أحمر المنقار، وهو أعظم طيور الواجب وأرفعها قدراً.السادس الصوغ- بضم الصاد المهملة وغين معجمة في الآخر وهو طائر مختلط اللون من السواد والبياض، أحمر الصدر، وأكثر ميله إلى الخضرة والأشجار.السابع العناز- بضم العين المهملة وتشديد النون وزاي معجمة في الآخر وهو طائر أسود اللون، أبيض الصدر، أحمر الرجلين والمنقار.الثامن العقاب وقد تقدم ذكره في الكلام على الجوارح حيث هو معدود منها ومن طير الواجب؛ ومما يتعلق بهذا المكان أنها منها: الأسود، والخوخية، والسفع، والأبيض، والأشقر؛ ومنها ما يأوي الجبال، وما يأوي الصاري، وما يأوي الغياض، وما يأوي حول المدن.وقد تقدم ذكر الخلاف في أن ذكرها من جنسها أو من جنس آخر في الكلام على الجوارح. وحكمها تحريم الأكل لأنها من ذوات المخلب من الطير، واختلف في قتلها هل هو مستحب أم لا؟ فجزم الرافعي والنووي من أصحابنا الشافعية في الحج باستحباب قتلها. وجزم النووي في شرح المهذب بأنها من القسم الذي لا يستحب قتله ولا يكره، وهو ما يجتمع فيه نفع ومضرة؛ وبه جزم القاضي أبو الطيب رحمه الله.التاسع النسر بفتح النون ويجمع في القلة على أنسر؛ وفي الكثرة على نسور، وسمي نسراً لأنه ينسر الشيء ويبتلعه.والنسر ذو منسر وليس بذي مخلب وإنما له أظفار حداد المخالب، وهو يسفد كما يسفد الديك. وزعم قوم أن الأنثى منه تبيض من نظر الذكر إليها وهي لا تحضن بيضها، وإنما تبيض في الأماكن العالية الظاهرة للشمس فيقوم حر الشمس للبيض مقام الحضن.والنسر حاد البصر يرى الجيفة من أربعمائة فرسخ، وكذلك حاسة شمه في الغاية؛ ويقال: إنه إذا شم الرائحة الطيبة مات لوقته؛ وهو أشد الطير طيراناً وأقواها جناحاً حتى يقال: إنه يطير ما بين المشرق والمغرب في يوم واحد؛ وإذا وقع على جيفة وعليها عقبان تأخرت ولم تأكل ما دام يأكل منها، وكل الجوارح تخافه، وهو في غاية الشره والنهم في الأكل، وإذا وقع على جيفة وامتلأ منها لم يستطع الطيران حتى يثب وثبات يرفع بها نفسه طبقة في الهواء حتى يدخل تحت الريح؛ وربما صاده الضعيف من الناس في هذه الحالة. والأنثى منه تخاف على بيضها وفراخها الخفاش فتفرش في أوكارها ورق الدلب لتنفر منه الخفاش؛ وهو من أشد الطير حزناً على فراق إلفه، حتى إذا فارق أحدهما الآخر مات حزناً.وهو من أطول الطير أعماراً حتى يقال: إنه يعمر ألف سنة وحكمه تحريم أكله لأنه يأكل الجيف.العاشر الأنيسة قال في حياة الحيوان: بذلك تسميه الرماة وإنما أسمه الأنيس.قال: وهو طائر حاد البصر، يشبه صوته صوت الجمل، ومأواه قرب الأنهار والأماكن الكثيرة المياه الملتفة الأشجار؛ وله لون حسن، وتدبير في معاشه.وقال أرسطو: إنه يتولد من الشقراق والغراب، وذلك بين في لونه.ويقال: إنه يحب الأنس، ويقبل الأدب والتربية، في صفيره وقرقرته أعاجيب، حتى إنه ربما أفصح بالأصوات كالقمري؛ وغذاؤه الفاكهة واللحم وغير ذلك. ومن شأنه ألفة الغياض. وحكمه الحل لأنه طيب غير مستخبث. فإن صح تولده من الشقراق والغراب فينبغي تحريمه.والأنيسة ذات ألوان مختلفةٍ، بدنها يميل إلى الغبرة، وعنقها يشتمل على خضرة وزرقة؛ ويقال: إنها أشرف طيور الواجب وأعزها وجوداً.الضرب الثاني: طيور الصيف:وهي التي يكثر وجودها فيه، وهي أربعة أطيار: الأول الكي بضم الكاف: وهو طير أغبر اللون إلى البياض، أحمر المنقار والحوصلة، رجلاه تضربان إلى السواد.الثاني الغرنوق بكسر الغين المعجمة وفتح النون ويقال فيه غرنيق بضم الغين وفتح النون ويجمع على غرانيق.قال الجوهري: وهو طائر أبيض من طير الماء طويل العنق، وتبعه الزمخشري على ذلك. وقال أبو خيرة: وسمي غرنيقاً لبياضه.وقال صاحب الصايد والمطارد: الغرنيق كركي إلا أنه أخضر طويل المنقار، وقيل: لونه كلون الكركي إلا أنه أسود الصدر والرأس، وله ذؤابتان في رأسه. وقل: ومن خصائها أن ريشها في شبيبتها يكون رمادياً، فإذا كبرت اسود وليس ذلك في سائر الطير، فإن الريش لا يحول بياضه إلى السواد بل يحول سواده إلى البياض كما في الغربان والعصافير ولخطاطيف.الثالث المرزم وهو طير أبيض في أطراف ريشه حمرة، طويل الرجلين والعنق؛ وهو حلال الأكل.الرابع الشبيطر- بضم الشين المعجمة وفتح الموحدة والطاء المهملة ويسمى: اللقلق أيضاً، ويعرف بالبلارح؛ وكنيته عند أهل العراق: أبو خديج، وهو طائر أبيض، أسود طرفي الجناحين، ورجلاه ومنقاره حمر؛ وهو يأكل الحيات ولكنه يوصف بالفطنة والذكاء.وفي حله عند الشافعية وجهان أصحهما في شرح المهذب والورضة: الحرمة، وإن كان من طير الماء.وسيأتي الكلام على ما يحمل من هذه الطيور الأربعة عشر بأعناقه وما يحمل منها بأسيافه فيما يتعلق بمصطلح الرماة في الكلام على كتابة قدم البندق في موضعه إنشاء الله تعالى. وطيور الواجب كلها حلال إلا النسر والعقاب.الصنف الثالث: ما عدا الطير الجليل مما يصاد بالجوارح وغيرها:وهو على ضربين:الضرب الأول: ما يحل أكله:وهو أنواع كثيرة لا يأخذه الحصر، ونحن نقتصر على ذكر المشهور من أنواعه.فمنها النعام وهو اسم جنس، الواحدة نعامة؛ وهو طائر معروف، مركب من صورتي جمل وطائر، ولذلك تسميه الترك: دواقش بمعنى طير جمل، وتسميه الفرس: اشتر مرك، ومعناه جمل وطائر. وتجمع النعامة على نعامات، ويسمى ذكرها: الظليم.ومن المتكلمين على طبائع الحيوان من لم يجعلها طيراً وإن كانت تبيض لعدم طيرانها؛ ومن الناس من يظن أنها متولدة من جمل وطير ولم يصح ذلك.ومساكنها الرمل، وتضع بيضها سطراً مستطيلاً بحيث لو مد عليها خيط لم تخرج واحدة منها عن الأخرى، ثم تعطي كل بيضة منها نصيبها من الحضن، لأنها لا تستطيع ضم جميع البيض تحتها، وإذا خرجت للطعم فوجدت بيض نعامة أخرى حضنته ونسيت بيضها، فربما حضنت هذه بيض هذه، وربما حضنت هذه بيض هذه، ولذلك توصف في الطير بالحمق، ويقال إنها تقسم بيضها أثلاثاً: فمنهما تحضنه، ومنه ما تجعله غذاءً لها، ومنه ما تفتحه وتجعله في الهواء حتى يتولد فيه الدود فتغذي به أفراخها إذا خرجت.وليس للنعام حاسة سمع ولكنه قوي الشم، يستغني بشمه عن سماعه حتى يقال: إنه يشم رائحة القانص من بعد.والعرب تقول: إن النعامة ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيها. وهو لا يشرب ماء، وإن طال عليه الأمد، ولذلك يسكن البراري التي لا ماء فيها. وأكثر ما يكون عدوها إذا استقبلت الريح.ومن خصائصها أنها تبتلع العظم الصلب والحجر والحديد فتذيبه معدتها حتى تدفعه كالماء، وتبتلع الجمر فيطفئه جوفها، وإذا رأت في أذن صغير لؤلؤة أو حلقة اختطفتها. وحكمه حل أكله إجماعاً. ومن خاصته أن مرارته سم وحي.ومنها الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو- وهو اسم جنس واحده إوزة، وجمعوه على إوزون، وهو مما يحب السباحة في البحر، وإذا خرج فرخه من البيضة سبح في الحال، وإذا حضنت الأنثى قام الذكر يحرسها لا يفارقها، ويخرج فرخها في دون الشهر من البيضة. وهو من الطيبات وغذاؤه جيد إلا أنه بطيء الهضم.ومنها البط- وهو من طيور الماء، واحدة بطة للذكر والأنثى وليس بعربي، وهو عند العرب من جملة الإوز.ومنها القرلى- بكسر القاف- ويسمى: ملاعب ظله. وهو طائر صغير الجرم من طيور الماء، سريع الاختطاف، لا يزال مرفرفاً على وجه الماء على جانب كطيران الحدأة، يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمعاً، ويرفع الأخرى حذراً؛ فإن أبصر في الماء ما يستقل بحمله من السمك أو غيره انقض عليه كالسهم المرسل فأخرجه من قعر الماء، وإن أبصر في الجو جارحاً في الأرض. وبه يضرب المثل في الإقبال على الخير والإدبار عن الشر، فيقال: كأنه قرلى، إن رأى خيراً تدلى، أو رأى شراً تولى.ومنها الغطاس- ويقال له: الغواص، وهو طائر أسود نحو الإوزة، يغرص في الماء فيستخرج السمك فيأكله. ووهم فيه في حياة الحيوان فجعله: القرلى.ومنها الدجاج- بفتح الدال المهملة وكسرها وضمها- حكاه ابن معن الدمشقي وابن مالك وغيرهما، وأفصحها الفتح وأضعفها الضم والواحدة دجاجة، والذكر والأنثى فيه سواء.قال ابن سيده: وسميت دجاجةً لإقبالها وإدبارها، يقال: دج القوم إذا مشوا بتقارب خطو، وقيل: إذا أقبلوا وأدبروا. والفرخ يخرج من البيضة بالحضن، وتارة بالصنعة والتدفئة بالنار، وإذا خرج الفرخ من البيضة خرج كاسياً ظريفاً سريع الحركة، يدعى فيجيب، ثم كلما مرت عليه الأيام حمق ونقص حسنه. ومما يعرف به الذكر من الأنثى في حالة الصغر أن يعلق الفرخ بمنقاره فإن اضطرب فهو ذكر، وإلا فهو أنثى.والدجاج يبيض في جميع السنة، وربما باضت الدجاجة في اليوم مرتين، ويتم خلق البيض في عشرة أيام، وتخرج لينة القشر فإذا أصابها الهواء تصلبت.وتشتمل البيضة على بياض وصفرة ويسمى: المح؛ ومن البياض يتخلق الولد؛ والصفرة غذاء له في البيضة يتغذاه من سرته، وربما كان للبيضة بياضان، ويتخلق من كل بياض فرخ، فإذا كبرت الدجاجة لم يبق لبيضها مح وحينئذ فلا يخلق منه فرخ. ثم الدجاج من الطيور الدواجن في البيوت.وقد ورد في سنن ابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أمر الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج. قال عبد اللطيف البغدادي: أمر كل قوم من الكسب بحسب مقدرتهم.ومن عجيب أمر الدجاجة أنها تمر بها سائر السباع فلا تحاماها، فإذا مر بها ابن آوى وهي على سطح رمت نفسها إليه، وهي توصف بقلة النوم وسرعة الانتباه ويقال: إن ذلك لخوفها وخور طباعها.ومن الدجاج نوع يقال له: الحبشي؛ أرقط اللون، متوحش؛ وربما ألف البيوت. والحكم في الجميع الحل.ومنها الديك- وهو ذكر الدجاج، ويجمع على ديكةٍ وديوك، هو أبله الطبيعة حتى إنه إذا سقط من حائط لم يكن له هداية ترشده إلى دار أهله، ومع ذلك فقد خصه الله تعالى بمعرفة الأوقات حتى رجح الرافعي من مذهب الشافعي رضي الله عنه اعتماد الديك المجرب وفاقاً للمتولي والقاضي حسين.ومن عجيب أمره أنه يقسط أوقات الليل تقسيطاً لا يخل فيه بشيء طال الليل أم قصر. ولكن قد ورد في معجم الطبراني وغيره: إن لله سبحانه وتعالى ديكاً أبيض، جناحاه موشيان بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، رأسه تحت العرش، وقوائمه في الهواء، يؤذن كل سحر فيسمع تلك الصيحة أهل السموات وأهل الأرض إلا الثقلين: الجن والإنس، فعند ذلك تجيبه ديوك الأرض؛ وحينئذ فيكون الديك في ذلك تابعاً. وقد ورد عدة أحاديث في النهي عن سب الديك، ومدح الديك الأبيض، والحث على اتخاذه.ومن حميد خصال الديك: أنه يسوي بين دجاجه، ولا يؤثر واحدة على الأخرى. ويقال: إنه يبيض في السنة بيضة؛ ويفرق بين بيضته وبيضة الدجاج أن بيضته أصغر من بيضة الدجاج، وهي مدورة لا تحديد في رأسيها.ومنها القطا- بفتح القاف- وهو طائر معروف واحده قطاة ويجمع على قطوات وقطيات، وأكثر ما يبيض ثلاث بيضات، ويسمى قطاً لحكاية صوته، لأنه يصيح قطا قطا ولذلك تصفها العرب بالصدق.قال الجوهري: وهو معدود من الحمام، وبه قال ابن قتيبة، وعليه جرى الرافعي في الحج والأطعمة؛ قال الشيخ محب الدين الطبري: والمشهور خلافه.ثم القطا نوعان: كدري وجوني، وزاد الجوهري نوعاً ثالثاً وهو الغطاط، فالكدري: غبر اللون، رقش البطون والظهور، صفر الحلوق، قصار الأذناب. والجوني: سود بطون الأجنحة والقوادم، وظهرها أغبر أرقط، تعلوه صفرة، وهي أكبر جرماً من الكدري، تعدل كل جونية كدريتين، والكدرية تفصح باسمها في صياحها، والجونية لا تفصح بل تقرقر بصوت في حلقها.ومن خاصتها أنها لا تسير إلا جماعة. ومن طبعها أنها تبيض في القفر على مسافة بعيدة من الماء؛ وتطلب الماء من مسافة عشرين ليلة وفوقها ودونها؛ وتخرج من أفاحيصها في طلب الماء عند طلوع الفجر فتقطع إلى حين طلوع الشمس مسيرة سبع مراحل، فترد الماء فتشرب ثم تقيم على الماء ساعتين أو ثلاثاً ثم تعود إلى الماء ثانية. والجونية تخرج إلى الماء قبل الكدرية، وهي توصف بالهداية فتأتي أفاحيصها ليلاً ونهاراً فلا تضل عنها، وتوصف بحسن المشي وبقلة النوم.ومنها الكروان- بفتح الكاف والراء- وهو طائر في قدر الدجاجة، طويل الرجلين، حسن الصوت، لا ينام الليل، ويجمع على كروان- بكسر الكاف- والأنثى: كروانة.ومنها الحجل بفتح الحاء المهملة والجيم- وهو طائر على قدر الحمام كالقطا، أحمر المنقار والرجلين؛ ويسمى: دجاج البر؛ ويقع على الذكر والأنثى؛ وقد يقال له: القبج أيضاً- بفتح القاف وسكون الموحدة وجيم في الآخر- يقال للذكر والأنثى منه: قبجة، ويسمى الذكر منه: اليعقوب. والقبج- بفتح القاف والموحدة وجيم في الآخر- ويقال في الأنثى منه: حجلة، وهو صنفان: نجدي وتهامي، فالنجدي أحمر الرجلين، والتهامي فيه بياض وخضرة؛ ومن شأنه أنه يأتي إلى مصر عند هيجان زرعها ويصيح صياحاً حسناً، تقول العامة: إنه يقول في صياحه: طاب دقيق السبل. ومن شأن الأنثى منه إذا لم تلقح أنها تتمرغ في التراب وتصبه على أصول ريشها فتلقح؛ ويقال: إنها تلقح بسماع صوت الذكر، وبريح يهب من قبله؛ وإذا باضت ميز الذكر الذكور منها فحضنها، وتحضن الأنثى الإناث، وكذلك في التربية. وفرخها يخرج كاسياً بزغب الريش كما في الدجاج.وفي المصايد والمطارد: أن القبج كثير السفاد، وأنه إذا اشتغلت عنه الأنثى ورأى بيضها كسره.قال التوحيدي: ويعيش الحجل عشر سنين ويعمل عشين، يجلس الذكر في واحد والأنثى في واحد، وهو من أشد الطيور غيرة على أنثاه حتى إن الذكرين ربما قتل أحدهما الآخر بسبب الأنثى، فمن غلب منهما دانت له.ومن طبعه أنه يأتي عش غيره فيأخذ بيضه ويحضنه، فإذا طارت الفراخ لحقت بأمهاتها التي باضتها؛ وفيه من قوة الطيران ما يظنه من لم يحققه عند طيرانه أنه حجر رمي بمقلاع لسرعته.ومنها القمري- بضم القاف وسكون الميم- وهو طائر معروف حسن الصوت، ويجمع على قماري غير مصروف. قال في المحكم: ويجمع على قمر أيضاً؛ والأنثى منه قمرية، ويقال للذكر منه: الورشان بفتح الواو والراء المهملة والشين المعجمة ويقال له أيضاً: ساق حر. قال البطليوسي: وسمي ساق حر، لصوته كأنه يقول ذلك، ويكنى: أبا الأخضر، وأبا عمران، وأبا الناجية.قال ابن السمعاني: والقمري منسوب إلى القمر، وهي بلدة تشبه الجص لبياضها؛ قال: وأظنها بمصر. وقال ابن سيده القمري طير صغير، وعدة في المحكم من الحمام. ويقال: إن الهوام تهرب من صوت القماري.قال القزويني: ومن خاصية القماري أنها إذا ماتت ذكورها لم تتزاوج إناثها. والورشان الذي هو ذكر القمري يوصف بالحنو على أولاده حتى إنه ربما قتل نفسه إذا رآها في يد القانص.قال عطاء: وهو يقول في صياحه:
لدوا للموت وابنو للخرابومنه نوع أسود حجازي يقال له: النوى، شجي الصوت جداً.ومنها الفاختة- بالفاء والخاء المعجمة والتاء المثناة والجمع الفواخت بفتح الفاء وكسر الخاء وهي طائر من ذوات الأطواق، حجازية في قدر الحمام، حسنة الصوت، ويقال: إن الحيات تهرب من صوتها، حتى يحكى أن الحيات كثرت بأرض، فشكا أهلها ذلك إلى بعض الحكماء، فأمرهم بنقل الفواخت إليها فانقطعت الحيات عنها. وفي طبعها الأنس بالناس؛ وتعيش في الدور، إلا أن العرب تسمها بالكذب، فإن صوتها عندهم تقول فيه: هذا أو إن الرطب، وهي تقول ذلك والنخل لم يطلع بعد؛ ولذلك تقول العرب في أمثالهم: أكذب من فاختةٍ.ومنها الدبسي بضم الدال وهو طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب بكسر الدال وذلك أنهم يغيرون في النسب فيقولون في النسبة إلى الدهر: دهري ونحو ذلك، وهو ضرب من الحمام. ثم هو أصناف: مصري وحجازي، وعراقي؛ وكلها متقاربة، لكن أفخرها المصري، ولونه الدكنة، وقيل: هو ذكر اليمام. وفي الصيف له مصيف، لا يعرف له وكر.ومنها الشفنين بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء ونون مكسورة بعدها ياء مثناة تحت ثم نون وهو الذي تسميه العامة بمصر: اليمام، وهو دون الحمام في المقدار، ولونه الحمرة مع كمودةٍ، وفي صوته ترجيع وتحزين. ومن شأنها أنها تحسن أصواتها إذا اختلطت. ومن طبعه أنه إذا فقد أنثاه لم يزل أعزب إلى أن يموت، وكذلك الأنثى إذا فقدت ذكرها؛ وفيه ألفة للبيوت، وعنده احتراس.ومنها الدراج بفتح الدال وكنيته أبو الحجاج وأبو خطار؛ وهو طائر ظاهر جناحية أغبر وباطنهما أسود، على خلقة القطا إلا أهه ألطف. وهو يطلق على الذكر والأنثى. والجاحظ يعده من جنس الحمام لأنه يجمع بيضه تحت جناحه كما يفعل الحمام. والناس يعبرون عن صوته بأنه يقول: بالشكر تدوم النعم.ويقال: إنه طائر مبارك، وهو كثير النتاج، يبشر بقدوم الربيع؛ وهو يصلح بهبوب الشمال، وصفاء الهواء، ويسوء حاله بهبوب الجنوب حتى لا يقدر على الطيران.ومنها العصفور بضم العين- وحكى ابن رشيق في كتاب الغرائب: فتحها، والأنثى: عصفورة وكنيته: أبو الصفو، وأبو محرز، وأبو مزاحم، وأبو يعقوب.قال حمزة: سمي عصفوراً لأنه عصى وفر؛ وهو أنواع كثيرة، وأشهرها المعروف بالدوري؛ ووكره العمران تحت السقوف خوفاً من الجوارح؛ فإذا خلت مدينة من أهلها ذهبت العصافير منها؛ وهو كثير السفاد حتى إنه ربما سفد في الساعة الواحدة مائ مرة، ولفرخه تدرب على الطيران حتى إنه يدعى فيجيب. قال الجاحظ: بلغني أنه يرجع من فرسخ.ومنها الشحرور بفتح الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة وهو طائر أسود فويق العصفور له صوت شجي؛ ويكون بأرض الشام كثيراً.ومنها الهزار بفتح الهاء والزاي المعجمة طائر نحو العصفور له صوت حسن ويسمى العندليب أيضاً، ويجمع على عنادل.ومنها البلبل بضم الموحدتين وسكون اللام الأولى والثانية وهو طائر أسود فوق العصفور، والحجري منه فوق ذلك؛ ويقال له: النغر بضم العين المهملة ومثناة فوقية في الآخر والجميل بضم الجيم وقد ثبت في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ لأمي فطيم يقال له: عمير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لنغر كان يلعب به.ومنها السماني بضم السين المهملة وفتح النون ولا تشدد ميمه وهو طائر معروف فوق العصفور ويجمع على سمانيات، وهو من الطيور التي لا يعرف من أين تأتي، بل يأتي في البحر الملح يغوص بأحد جناحيه في الماء ويقيم الآخر كالقلع للسفينة فتدفعه الريح حتى يأتي الساحل؛ وكثيراً ما يوجد ببلاد السواحل، وله صوت حسن. ومن شأنه أنه يسكت في الشتاء فإذا أقبل الربيع صاح.ومنها الحسون وتسميه أهل الجزيرة والشام وحلب وتوابعها: زقيقية، وهو طائر فطن، ويسميه الأندلسيون: أبو الحسن، والمصريون: أبو زقاية، وربما أبدلوا الزاي منه سيناً، وهو عصفور ذو ألوان: حمرة وصفرة وبياض وسواد وزرقة وخضرة، وهو قابل للتعليم، يعلم أخذ الشيء كالفلس ونحوه من يد الإنسان على البعد والإتيان به لصاحبه.ومنها أبو براقش بكسر القاف وبالشين المعجمة وهو طائر كالعصفور يتلون ألواناً، وبه يضرب المثل في التلون.ومنها الزراغ بزاي وغين معجمتين بينهما ألف وهو ضرب من الغربان صغير أخضر اللون لطيف الشكل حسن المنظر، وقد يكون أحمر المنقار والرجلين، وهو الذي يقال له: غراب الزيتون، سمي بذلك لأنه يأكل الزيتون.ومنها الغداف بضم الغين المعجمة وبالدال المهملة والفاء في آخره وهو غراب الغيط ويجمع على غدفان بكسر الغين.قال ابن فارس: هو الغراب الضخم. وقال العبدري: هو غراب صغير أسود، لونه كلون الرماد. وقد قال النووي في الروضة بتحريمه وإن كان الرافعي قد جزم بحله؛ ورجحه صاحب المهمات.ومنها غراب الزرع وهو غراب أسود المنقار. وفيه وجه بالتحريم.الضرب الثاني ما يحرم أكله:وهوأنواع كثيرة أيضاً: منها الطاوس ويجمع على طواويس وهو طائر في نحو مقدار الإوزة حسن اللون، والذكر منه غاية في الحسن؛ له في رأسه رياش خضر قاتمة كالشربوش، وفي ذنبه ريش أخضر طويل في أحسن منظر، وليس للأنثى شيء من ذلك؛ وهو في الطير كالفرس في الدواب عزاً وحسناً؛ وفي طبعه الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه؛ والأنثى منه تبيض بعد ثلاث سنين من عمرها، وفي هذا الحد يكمل ريش الذكر ويتم لونه. وبيضه مرة واحدة في السنة، ويكون بيضه من اثنتي عشرة بيضة إلى ما حولها، ولا يبض متتابعاً. وسفاده في أيام الربيع. وفي الخريف يلقي ريشه كما يلقي الشجر ورقه حينئذ؛ فإذا بدا طلوع أوراق الأشجار طلع ريشه. وهو كثير العبث بالأنثى إذا حضنت وربما كسر بيضها؛ ولذلك يحضن بيضه تحت الدجاج؛ لكن لا تقوى الدجاجة على حضن أكثر من بيضتين منها، وتتعاهد الدجاجة بالطعمة والسقية وهي راقدة عليه، كيلا تقوم عنه فيفسد بالهواء، إلا أن ما تحضنه الدجاجة يكون ناقص الجثة عما تحضنه أنثاه؛ وليس له من الحسن والبهجة ما لذلك؛ ومدة حضنه ثلاثون يوماً؛ وفرخه يخرج من البيضة كالفروج كاسياً بالريش يلقط الحب للحال.ومنها السمندل بفتح السين المهملة والميم وسكون النون وبفتح الدال المهملة ولام في الآخر وقال الجوهري: السندل بغير ميم. وقال ابن خلكان: السمند بغير لام؛ وهو طائر يكون بأرض الصين والهند؛ ومن خاصته أنه لا تؤثر النار فيه حتى يقال: إنه يبيض ويفرخ فيها ويستلذ بمكثه فيها. ويتخذ من ريشه مناديل ونحوها، فإذا اتسخت ألقيت في النار، فتأكل النار وسخها ولا تتأثر هي في نفسها.قال ابن خلكان في ترجمة يعقوب بن صابر المنجنيقي: رأيت منه قطعة ثخينة منسوجة على هيئة حزام الدابة في طوله وعرضه، فألقيت في النار فما أثرت فيها، فغمس أحد جوانبها في الزيت وجعل في النار فاشتعل وبقي زماناً طويلاً ثم أطفئ وهو على حاله لم يتغير. قال: ورأيت بخط عبد اللطيف البغدادي: أنه أهدي للظاهر ابن السلطان صلاح الدين صاحب حلب قطعة منه عرض ذراع في طول ذراعين، فغمست في الزيت وقربت من النار فاشتعلت حتى فني الزيت، ثم عادت بيضاء كما كانت. وبعضهم يقول: إنه وحش كالثعلب وإن ذلك يعمل من وبره.ومنها البيغاء بباءين مفتوحتين، الأولى منهما مخففة والثانية مشددة وغين معجمة بعدها ثم ألف وهو المعبر عنه بالدرة بدال مهملة مضمومة وقال ابن السمعاني في الأنساب: هي بإسكان الباء الثانية، وهي طائر أخضر اللون في قدر الحمام يحاكي ما يسمعه من اللفظ؛ ثم هي على ضربين: هندي وهي أكبر جثة ومنقارها أحمر، ونوبي وهي دونها منقارها أسود؛ ويقال: إن منها نوعاً أبيض؛ ويذكر أنه أهدي لمعز الدولة ابن بويه ببغاء بيضاء اللون سوداء المنقار والرجلين، على رأسها ذؤابة فستقية. وهي طائر دمث الأخلاق، ثاقب الفهم، له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين؛ تتخذه الملوك والأكابر لينم بما يسمع. ومن شأنه أنه يتنأول طعمه برجله كما يتنأوله الإنسان بيده؛ والهندي منه أقرب إلى التعليم من النوبي.ومنها أبو زريق بزاي مضمومة ثم راء مهملة وفي آخر قاف ويقال له: القيق بكسر القاف والزرياب بزاي معجمة مكسورة ثم راء مهملة ساكنة ثم ياء مثناة تحت، وبعد الألف باء موحدة وهو طائر ألوف للناس يقبل التعليم، سريع الإدراك لما يعلم؛ وقد يزيد على الببغاء إذا أنجب، بل إذا تعلم جاء بالحروف مبينة حتى يظن سامعه أنه إنسان، بخلاف الببغاء فإنها لا تفصح كل الإفصاح.ومن غريب ما يحكى في أمره ما حكاه صاحب منطق الطير: أن رجلاً خرج من بغداد ومعه أربعمائة درهم، لا يملك غيرها، فوجد في طريقه عدة من فراخه فاشتراها بما معه، ثم رجع إلى بغداد فعلقها في أقفاص في حانوته، فهبت عليها ريح باردة فماتت كلها إلا واحداً كان أضعفها وأصغرها، فثقل ذلك عليه وبات ليلته تلك يبتهل إلى الله تعالى بالدعاء وينادي: يا غياث المستغيثين أغثني! فلما أصبح إذا ذلك الفرخ الذي بقي يصيح بلسان فصيح: يا غياث المستغيثين أغثني؛ فاجتمع الناس عليه يسمعون صوته؛ فاجتازت جارية للخليفة فاشترته منه بألف درهم.ومنها الهدهد بضم الهاءين وإسكان الدال المهملة بينهما وهو طائر معروف ذو خطوط موشية وألوان، ويجمع على هداهد. ويذكر عنه أنه يرى الماء من باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الزجاج قوة ركبها الله تعالى فيه ولذلك عني به سليمان عليه السلام مع صغره كما قال البهيقي في شعب الإيمان ويقال: إنه كان ذليلاً لسليمان عليه السلام على الماء؛ وقصته مع سليمان مذكورة في التنزيل.وقد ذكر الزمخشري أن سبب تخلفه عن سليمان أنه رأى هدهداً آخر، فحكى له عظيم ملك سليمان؛ فحكى له ذلك الهدهد عظيم ملك بلقيس باليمن؛ فذهب ليكشف الخبر فلم يرجع إلا بعد العصر؛ فلما عدا إليه توعده، فإوخى رأسه وجناحيه تواضعاً بين يديه، وقال: يا نبي الله، اذكر وقوفك بين يدي الله! فارتعد سليمان وعفا عنه.ومنها الخطاف بضم الخاء المعجمة ويجمع على خطاطيف وهو طائر في قدر العصفور، أسود وباطن جناحيه إلى الحمرة؛ والناس يسمونه عصفور الجنة لأنه يعرض عن أقواتهم ويقتات البعوض والذباب. ومن شأنه السكنى في البيوت المعمورة بالناس في أفاحيص يبنيها من الطين؛ ويختار منها السقوف والأماكن التي لا يصل إليه فيها أحد.وقد ذكر الثعلبي في تفسيره في سورة النمل: أن سبب قرب الخطاطيف من الناس أن الله تعالى لما أهبط آدم إلى الأرض، استوحش؛ فآنسه الله تعلى بالخطاف وألزمه البيوت؛ فهو لا يفارق بني آدم أنسالهم. والخفاش يعاديه، فلذلك إذا أفرخ جعل في عشه قضبان الكرفس لينفر الخفاش عنها.ومن عادته أنه لا يفرخ في عشر عتيق حتى يطينه بطين جديد، ولا يلقي شيئاً من ذرقه في عشه بل يلقيه إلى ما شاء. وإذا سمع حس الرعد يكاد يمو. ويوجد في عشه حجر اليرقان وهو حجر صغير فيه خطوط بين الحمرة والسواد إذا علق على من به اليرقان أو شرب من سحالته بريء؛ وإنما يأتي بهذا الحجر إذا أصاب فراخه اليرقان؛ ولذلك يحتال بعض الناس بلطخ فراخه بالزغفران ليظن أن اليرقان قد أصابها فيأتي إليها بهذا الحجر فيؤخذ منه.ومن الخطاطيف نوع آخر الطف قدراً من هذا، يسكن شطوط الأنهار وجوانب المياه. وعدوا من أنواعه أيضاً الذي يسميه أهل مصر: الخضيري؛ وهو طائر أخضر دون الببغاء في المقدار لا يزال طائراً وهو يصيح؛ يقتات الفراش والذباب.ومنها الصرد- بضم الصاد وفتح المهملة ودال مهملة في الآخر ويجمع على صردان قال ابن قتيبة: وسمي صرداً، حكاية لصوته، ويسمى: الواق- بكسر القاف- وكنيته: أبو كثير؛ وهو طائر فوق العصفور، نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم الرأس، ضخم المنقار والبراثن؛ لا يرى إلا في شعفة أو شجرة بحيث لا يقدر عليه أحد؛ وله صفير مختلف.ومن شأنه أنه يصيد العصافير وما في معناها؛ فيصفر لكل طير يريد صيده بلغته، يدعوه إلى التقرب منه فيثب عليه فيأكله. والعرب بتتشاءم به وتنفر من صياحه. وهو مما وردت الشريعة بالنهي عن قتله.ومنها العقعق- بعينين مهملتين ومفتوحتين بينهما قاف ساكنة- وربما قيل فيه: القعقع على القلب.قال الجاحظ: سمي بذلك لأنه يعق فراخه فيتركهم أياماً بلا طعم. ويقال لصوته: العقعقة؛ وهو طائر على قدر الحمامة في شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة؛ ذو لونين: أبيض وأسود، طويل الذنب.ومن شأنه أنه لا يأوي تحت سقف ولا يستظل به، بل يهيء وكره في المواضع المشرفة؛ وفي طبعه الزنا والخيانة؛ ويوصف بالسرقة والخبث. وإذا رأى حلياً أو عقداً اختطفه؛ والعرب تضرب به المثل في جميع ذلك. وإذا باضت الأنثى منه أخفت بيضها بورق الدلب خوفاً عليه من الخفاش، فإنه متى قرب من البيض مذر وتغير من ساعته. ويقال: إنه يخباً قوته كما يخبؤه الإنسان والنملة إلا أنه ينسى ما يخبؤه. وبعضهم يعده في جملة الغربان. وفيه وجه عندنا بحل أكله.ومنها الشقراق بفتح الشين المعجمة وسكون القاف وألف بين الراء المهملة والقاف الثانية- ويجوز فيه كسر الشين أيضاً وربما قلبوه فقالوا: الشرقاق؛ ويسمى: الأخيل أيضاً؛ وهو طائر صغير بقدر الحمام أخضر مشبع الخضرة، حسن المنظر في أجنحته سواد. والعرب تتشاءم به.وفي طبعه الشره حتى إنه يسرق فراخ غيره. وعده الجاحظ نوعاً من الغربان؛ ويكثؤ ببلاد الشام والروم وخراسان؛ ولا يزال متباعداً من الإنس، يألف الروابي ورؤوس الجبال؛ إلا أنه يحضن بيضه في عوالي العمران التي لا تنالها الأيدي. وعشه شديد البنيان، وله مشتى ومصيف.قال الجاحظ: وهو كثير الاستغاثة، إذا مر به طائر ضربه بجناحه وصاح كأنه هو المضروب. وفيه وجه بحل أكله.ومنها الغراب الأبقع- قال الجوهري: وهو الذي فيه بياض وسواد، ويسمى: غراب البين أيضاً؛ قال صاحب المجالسة: سمي بذلك لأنه بان عن نوح عليه السلام حين أرسله لينظر الماء فذهب ولم يرجع؛ قال ابن قتيبة: وجعل يسفدها مواجهة ملقاة على ظهرها؛ والأنثى تبيض أربع بيضات وخمساً؛ وإذا خرجت الفراخ من البيض نفر عنها الأبوان لبشاعة منظرها حينئذ، فتغتذي من البعوض والذباب الكائن في عشها حتى ينبت ريشها فيعود الأبوان إليها؛ وعلى الأنثى الحضن على الذكر أن يأتيها بالطعم. وفيه حذر شديد وتناصر، حتى إنه إذا صاح الغراب مستنصراً اجتمع إليه عدة من الغربان.ومنها الغراب الأسود الكبير وهو الجبلي. وفيه وجه بحله.ومنها الحدأة بكسر الحاء، والهمز الطائر المعروف، ويجمع على حدإ وحدءان. ومن ألوانها السود والرمد. وهي لا تصيد بل تخطف.ومن طبعها أنها تصف في الطيران وليس ذلك لشيء من الكواسر غيرها. وزعم ابن وحشية وابن زهر: أن الحدأة والعقاب يتبدلان، فتصير الحدأة عقاباً والعقاب حدأة. وربما قيل: الغراب بدل العقاب. ويقال إنها تصير سنة ذكراً وسنة أنثى. ويقال إنها أحسن الطير مجاورة لما جاورها من الطير حتى لو ماتت جوعاً لا تعدو على فرخ جارتها.وفي طبعها أنها إنما تختطف ممن تختطف منه من يده اليمنى دون اليسرى حتى يقال: إنها عسراء. وقد ثبت في الصحيحين حل قتلها في الحل والحرم.ومنها الرخمة- بفتح الراء المهملة والخاء المعجمة- وكنيتها: أم جعران، وأم رسالة، وأم عجيبة، وأم قيس، وأم كصير. ويقال لها: الأنوق- بفتح الهمزة وهي طائر أبقع ببياض وسواد، فوق الحدأة في المقدار تأكل الجيف. وهي معدودة في بغاث الطير. وهي تسكن رؤوس الجبال العالية وأبعدها من أماكن أعدائه؛ ولذلك تضرب العرب المثل ببيضه فيقولون: أعز من بيض الأنوق والأنثى لا تمكن من نفسها غير ذكرها وتبيض بيضة واحدة وربما باضت بيضتين.ومنها البومة بضم الباء الموحدة وفتح الميم- للذكر والأنثى؛ وهو طائر من طير الليل في قدر الإوزة، لها وجه مستدير بالريش النابت حوله، يشبه وجه الآدمي، في صفرة عينين وتوقدهما. ويقال للذكر منها: والطير بجملته يعاديها من أجل ذلك؛ فإذا رأوها في النهار قتلوها ونتفوا ريشها؛ ومن ثم يجعلها الصيادون في شباكهم ليقع عليها الطير فيقتنضونها؛ فهي لا تظهر بالنهار لذلك.ونقل المسعودي في مروج الذهب عن الجاحظ أنها إنما تمتنع من ظهورها في النهار خوفاً من أن تصاب بالعين لحسنها وجمالها، لأنها تصور في نفسها أنها أحسن الحيوان. ومن طبعها سكنى الخراب دون العامر.ومن غريب ما يحكى ما ذكره الطرطوشي في سراج الملوك: أن عبد الملك بن مروان أرق ليلة فاستدعى نميراً يحدثه، فكان مما حدثه أن قال: يا أمير المؤمنين كان بالبصرة بومة وبالموصل بومة، فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة بنتها لابنها؛ فقالت بومة البصرة: لا أفعل حتى تجعلي في صداقها مائة ضيعة خراب؛ فقالت بومة الموصل: لا أقدر على ذلك الآن ولكن إن دام والينا سلمه الله علينا سنة واحدة فعلت؛ فاستيقظ لها وجلس للمظالم.ومنها البؤة بضم الباء وفتح الهمزة- قال الجوهري: وهو طائر يشبه البومة إلا أنه أصغر منها. وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب نحوه، ويقال له البوهة أيضاً؛ وهي من طير الليل أيضاً. ولا يخفى أنها التي يسميها الناس في زماننا المصاصة ويزعمون أنها على الأطفال فتمص أنوفهم.ومنها الخفاش- بضم الخاء المعجمة وتشديد الفاء وبالشين المعجمة، ويجمع على خفافيش- وهو طائر غريب الشكل والوصف لا ريش عليه؛ وأجنحته جلدة لا صقة بيديه، وقيل لا صقة بجنبه. وسمي خفاشاً لأنه لا يبصر نهاراً، وبه سمي الرجل: أخفش؛ والعامة تسميه الوطواط، وقيل: الخفاش الصغير، والوطواط الكبير، ويقال: إن الوطواط هو الخطاف لا الخفاش. وليس هو من الطير في شيء، فإن له أسناناً وخصيتين، ويحيض ويضحك كما يضحك الإنسان، ويبول كما تبول ذوات الأربع، ويرضع ولده من ثديه.ولما كان لا يبصر نهارً التمس وقتاً يكون بين الظلمة والضوء وهو قريب غروب الشمس، لأنه وقت هيجان البعوض، فالبعوض يخرج في ذلك الوقت يطلب قوته من دماء الحيوان؛ والخفاش يخرج لطلب الطعم فيقع طالب رزق على طالب رزق. ويقال: إنه هو الذي خلقه المسيح عليه السلام من الطين، ونفخ فيه فكان طيراً بإذن الله. قال بعض المفسرين: ومن أجل ذلك كان مبايناً لغيره من الطيور، ولذلك سائر الطيور مبغضة له وتسطو عليه؛ فما كان منها يأكل اللحم أكله، وما كان منها لا يأكل اللحم قتله؛ وهو شديد الطيران، سريع التقلب؛ يقتات البعوض والذباب وبعض الفواكه. وهو موصوف بطول العمر حتى يقال: إنه أطول عمراً من النسر؛ وتلد الأنثى ما بين ثلاثة أفراخ وسبعة، وكثيراً ما يسفد وهو طائر في الهواء. وهو يحمل ولده معه إذا طار تحت جناحه، وربما قبض عليه بفيه حنوا عليه، وربما أرضعت الأنثى ولدها وهي طائرة. وفي طباعه أنه متى أصابه ورق الدلب خدر ولم يطر. وقد ورد النهي عن قتله.فإذا عرف الكاتب أحوال الطير وخواصها، تصرف فيها بحسب ما يحتاج إليه في نظمه ونثره، كما في قول الشاعر:
وإذا السعادة لاحظتك عيونها ** نم فالمخاوف كلهن أمانواصطد بها العنقاء فهي حبائل ** واقتد بها الجوزاء فهي عنانإشارة إلى عظم العنقاء وعدم القدرة على مقاومتها؛ ومع ذلك تنقاد بالسعد. وكما في قول أبي الفتح كشاجم، مخاطباً لولده يطلب البرمنه:
اتخذ في خلة في الكراكي ** أتخذ فيك خلة الوطواطأنا إن لم تبرني في عناء ** فببري ترجو جواز السراطيشير إلى ما تقدم من أن في طبع الكركي بر والديه إذا كبرا، كما أن في طبع الوطواط بر أولاده بحيث يحملها معه إلى حيث توجه؛ وكما في قول الشاعر:
مثل النهار يزيد إبصار الورى ** نوراً ويعمي أعين الخفاشإشارة إلى أن الخفاش لا يبصر نهاراً، بخلاف سائر أرباب الأبصار؛ وكما قيل في وصف شارد عن القتال:
وهم تركوه أسلح من حبارى ** رأى صقراً وأشرد من نعاميريد ما تقدم مما يعرض للحبارى من إرسالها سلحها على الجارح عند اقتناصه لها؛ وأن النعام في غاية ما يكون في البرية من الشراد والنفار، ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى.الصنف الرابع: الحمام:وقد اختلف في الحمام في أصل اللغة؛ فنقل الأزهري عن الشافعي رضي الله عنه أن الحمام يطلق على كل ما عب وهدر وإن تفرقت أسماؤه، فيدخل فيه الحمام، واليمام، والدباسي، والقماري، والفواخت وغيرها. وذهب الأصمعي إلى أن الحمام يطلق على كل ذات طوق كالفواخت والقماري وأشباهها. ونقل أبو عبيد عن الكسائي سماعاً منه أن الحمام هو الذي لا يألف البيوت، وأن اليمام هو الذي يألف البيوت؛ لكن الذي غلب عليه إطلاق الحمام هذا النوع المخصوص المعروف.ثم هو على قسمين: أحدهما ما ليس له اهتداء في الطيران من المسافة البعيدة.والثاني ما له اهتداء، ويعرف بالحمام الهدي وهو المراد هنا، وقد اعتنى الناس بشأنه في القديم والحديث، واهتم بأمره الخلفاء؛ كالمهدي ثالث خلفاء بني العباس، والواثق، والناصر، وتنافس فيه رؤساء الناس بالعراق، لاسيما بالبصرة.فقد ذكر صاحب الروض المعطار: أنهم تنافسوا في اقتنائه، ولهجوا بذكره، وبالغوا في أثمانه حتى بلغ ثمن الطائر الفاره منها سبعمائة دينار، وكانت تباع بيضة الطائر المشهور بالفراهة بعشرين ديناراً. وإنه كان عندهم دفاتر بأنساب الحمام كأنساب العرب. وإنه كان لا يمتنع الرجل الجليل ولا الفقيه ولا العدل من اتخاذ الحمام والمنافسة فيه والإخبار عنهان والوصف لأثرها والنعت لمشهورها، حتى وجه أهل البصرة إلى بكار بن قتيبة البكرالديار المصرية والبلاد الشامية من الموصل وأن أول من اعتنى به من الملوك ونقله من الموصل: الشهيد نور الدين بن زنكي صاحب الشام رحمه الله في سنة خمس وستين وخمسمائة. وحافظ عليه الخلفاء الفاطميون بمصر، وبالغوا حتى أفردوا له ديواناً وجرائد بأنساب الحمام. وقد اعتنى بعض المصنفين بأمره؛ حتى صنف فيه أبو الحسن بن ملاعب القواس البغدادي كتاباً للناصر لدين الله العباسي، صنف فيه أبو الحسن بن ملاعب القواس البغدادي كتاباً للناصر لدين الله العباسي، ذكر فيه أسماء أعضاء الطائر، ورياشه، والوشوم التي توشم في كل عضو، وألوان الطيور، وما يستحسن من صفاتها، وكطيفية إفراخها، وبعض السافات التي أرسلت منها، وذكر شيء من نوادرها وحكاياتها ما يجري مجرى ذلك.وذكر في التعريف: أن القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر صنف فيها كتاباً سماه تمائم الحمائم؛ ويتعلق الغرض منها بأمور.الأمر الأول ذكر ألوانها قال أبو الحسن القواس: وقد أكثر الناس من ذكر ألوانها؛ ويرجع القصد فيها إلى ذكر ألوان ستة: اللون الأول البياض- ومنه الأبيض الصافي، والأشقر؛ وهو ما كان يعلوه حمرة؛ فإن كان الغالب في شقرته البياض قيل: فضي، فإن زاد قيل: أشقر.اللون الثاني الخضرة- إن كانت خضرته مشبعة إلى السواد قيل: أخضر مسني، فإن كان دون ذلك قيل: نبتي الخضرة، فإن كان دون ذلك قيل: صافي الخضرة؛ فإن تكدرت خضرته بأن لم يكن صافي الخضرة قيل: أسمر.اللون الثالث الصفرة- وهي عبارة عن أن تكون خضرته تميل إلى البياض؛ فإن كان صافياً قيل: أصفر قرطاسي.اللون الرابع الحمرة- إذا كان شديد الحمرة قيل: عنابي؛ فإن كان دون ذلك قيل: خمري؛ فإن كان دون ذلك قيل: خلوقي؛ فإن كانت حمرته تضرب إلى الخضرة قيل: أكفأ؛ فإن كانت حمرته تضرب إلى البياض قيل: أحمر صدقي.اللون الخامس- السواد- إذا كان شديد السواد لا بياض فيه قيل: أسود مطبق؛ فإن كان لون سواده ناقصاً قيل: أسود أخلس؛ فإن كان سواده يضرب إلى الخضرة قيل: أسود رمادي؛ فإن كان في سواده مائية قيل: أسود براق، فإن كان ساقاه أيضاً أسودين قيل: اسود حالك، وأسود زنجي.اللون السادس النمري- وهو أن يكون في الطائر نقط يخالف بعضها بعضاً؛ ويختلف الحال فيه باختلاف كبر النقط وصغرها، فتارة يقال: مدنر، وتارة يقال: ملمع، وتارة يقول: أبرش، وتارة يقال: موشح، وتارة يقالك أبقع، وتارة يقال: أبلق، وتارة يقال: دباسي، وتارة يقال: مدرع، إلى غير ذلك مما لا يستوفي كثرة. ثم إن كان الطائر أكحل العينين وحول عينيه حمرة قيل: فقيع، فإن كان اصفر العين قيل: أصفر زرنيخي؛ فإن كان أبيض العنق قيل: هلالي، وهو أحسنها، والأصفر العين بعده؛ فإن كانت العين بيضاء وفيها حمرة قيل: رماني العين.الأمر الثاني في عدد ريش الجناحين والذنب المعتد به وأسمائها أما الجناحان فإن فيهما عشرين ريشة، في كل جناح منهما عشر ريشات، الأولى منها وهي التي في طرف الجناح تسمى: الصمة؛ والثانية وهي التي بعدها تسمى: المضافة الرئيسية؛ والثالثة وهي التي بعدها تسمى: الواسطية؛ والرابعة وهي التي بعدها تسمى: المضافة؛ والخامسة وهي التي بعدها تسمى: المنظفة؛ والسادسة وهي التي بعدها تسمى: المنحدرة؛ والسابعة وهي التي بعدها تسمى: الناقصة؛ والثامنة وهي التي بعدها تسمى: المونسة؛ والتاسعة وهي التي بعدها تسمى: المزاملة، والعاشرة وهي التي بعدها تسمى: المعينة.وبعضهم يسمي الأولى: الصغيرة، والثانية: الرقيقة، والثالثة: الموفية، والرابعة: الباحلة، والخامسة: الحيرة، والسادسة: الصرافة، والسابعة: ممسكة الرمي، والثامنة والتاسعة: الحافظتين، والعاشرة: الملكة.وربما كان في كل جناح إحدى عشرة ريشة، فيسمى الطائر حينئذ: أعلم.ولهذه الريشات العشر عشر ريشات مع كل واحدة منها رادفة، وهي الريش الصغار التي تغطي قصب الجناح من ظاهره؛ ولكل ريشة من هذه الريشات العشر ريشة صغيرة تغطي قصبتها؛ لكل واحدة منها اسم يخصها.ومن ريش الجناح أيضاً: الخوافي، وهي الريش المستقر مع العشر ريشات الطوال المنقلب برؤوسه إلى مؤخر الجناح؛ وهي تسع ريشات، الأولى منها تسمى: الحدقة، والثانية: الرتمة، والثالثة: الغرة، والرابعة: الحز، والخامسة: الجائزة، والسادسة: المسلمة، والسابعة: الملازمة، والثامنة: الشعثة، والتاسعة: اللامعة؛ وبعضهم يسمي الأولى: بنت الملكة، والثانية: الإبرة، والثالثة: المقشعرة، والرابعة: الصافية، والخامسة: المصفية، والسادسة: المصفرة، والسابعة: الزرقاء، والثامنة: السوداء، والتاسعة: المزرقة، وعد فيها عاشرة تسمى: المخضرة؛ ولكل ريشة من الريشات التسع ريشة صغيرة تغطي قصبتا لها اسم يخصها أيضاً.وبعد الخوافي: الغفار، ولكل ريشة من الغفار ريشة صغيرة من باطنها تغطي قصبتها.ومن ريش الجناحين: المقومات، وهي ثلاث ريشات في طرف الجناح، تسمى: الزوائد؛ ومن فوقها ثلاث ريشات صغار تغطي قصبتها، تسمى: الغواشي، وأصلها مع أصل أيضاً.وأما الذنب، فالمعتبر فيه اثنتا عشرة ريشة من كل جانب: منه ست ريشات تسمى الأولى منها: الغزالة، والثانية: العروس، والثالثة: الباشقة، والرابعة: الباقية، والخامسة: المجاورة، والسادسة: العمود، ومن الجانب الآخر كذلك.الأمر الثالث الفرق بين الذكر والأنثى وقد ذكروا بينهما فروقاً؛ منها أن الأنثى إذا تمشت قدمت الرجل اليسرى، والذكر يقدم الرجل اليمنى، ومنها أن ريش الذكر أبو الحسن القواس: علامته أن يكون رأسه مكعباً، وعينه معتدلة، غير ناتئة ولا غائرة، ولا فاترة، ولا قلقة منزعجة، وأن يكون منقاره غليظاً قصيراً، وأن يكون وسط المنخرين مكلثم القرطميتن أهرت الشدقين، واسع الصدر، نقي الريش، طويل الفخذين، قصير الساقين، غليظ الأصابع، شثن البراثن، طويل القوادم منغير إفراط.ويستحب فيه قصر الذنب ودقته، واجتماع ريشه من غير تفرق؛ وأن يكون ظهره معتدلاً والى القصر أقرب؛ وأن يكون جؤجؤه، وهو جانب الصدر، طويلاً ممتداً؛ وعنقه طويلاً منصباً؛ وريش قوامه وخوافيه مبنياً متطابقاً بعضه مع بعض من غير تفرق ولا تمعط؛ وأن يكون شديد اللحم مكتنزاً، غير رخوٍ ولا رهل.ويستحب فيه أيضاً أنيكون قليل الرعدة عند الفزع، سريع اللقط للحب؛ خفيف الحركة والنهوض والنزول منغير طيش ولا اختلاط؛ وأن يكون ظهره مسطحاً لا أحدب ولا أوقص؛ ويستحب فيه إذا وقف أن ينصب صدره، ويرفع عنقه، ويفتح ما بين فخذيه شبه البازي.ومن علامة فراهته أنه إذا طال عليه الطيران وأراد النزول على سطحه ألا يدلي رجليه حتى يقع صدره على سطحه لأنه إذا دلى ساقيه كن عيباً عظيماً، يقولون: قد انحلت سراويله بمعنى أنه قد أدى جميع ما عنده من القوة والطاقة، ويكره فيه دقة المغرز، وطل الذنب، وتفرق الريش.الأمر الخامس الفراسة في الطائر من حال صغره قبل الطيران قالوا من علامة الطائر الفارة في صغره: أن يكون حديد النظر، شديد الحذر، خفيف اللحم، قليل الريش، سريع النهضة، كثير التلفت في الجو، ممتد العظم، مستوياً، لطيف الذنب، خارج العنق، قصير الساقين، طويل الفخذين، محجلاً، مذيل المنقار، مدور القراطم، مضاعف المحاجر، يلزم موضعاً واحداً من صغره، إلى ازدواجه، فإذا ازدوج على السطح يكون حريصاً على طائرته، حسن الأخلاق معها لا يطردها طرد الكلاب ولا يغتال غيلة الذئاب، قليل الذرق كثر الدهن، مدلا بنفسه، كأنه يعلم أنه فاره. فإن كان فيه بعض هذه الخصال كانت فراهته على قدر ما فيه من ذلك.قال أبو الحسن الكاتب: ومن علامة شهامة الفرخ أن تكون فيه الحركة وهو تحت أبيه وأمه، وكلما جمعته لتضمه تحتها، خرج من تحتها ويعتلق للخروج؛ وأن يكون ريش رأسه كأن فيه جلحاً وريش جسده وجناحه مستطيلاً عند نبعه من جسده، وأن يطول ريشه حتى يغطي ظهره ولا ينتشر إلا بعد ذلك؛ وأن يكون من جؤجؤ الصدر إلى مغرزة أقصر من بطنه إلى رأس براثنه.وفي الحمام طائر يقال: له: الأندم، وصفته أن يكون أسود المنقار ليس فيه بياض، ورأس منقاره وأصله سواء، لا تحديد في رأسه؛ عريض القراطم غليظ الشدقين، منتشر المنخرين، جهوري الصوت، غائر العين؛ قال أبو الحسن القواس: ولا تكون هذه الصفة إلا في الطائر الفاره الأصيل، الكريم الأب والأم.الأمر السادس بيان الزمان والمكان اللائقين بالإفراخ أما الزمان فأصلح أوقات التأليف: أيلول، وتشرين الأول، وتشرين الثاني، وآذار، ونيسان، وأيار، فإذا وقع الإفراخ في شيء من هذه الأوقات كانت الفراخ أقوياء نجباء، أذكياء، ونهوا عن الإفراخ في كانون الأول، وكانون الثاني، وشباط، وآب، وتموز، وحزيران، فإن الذي يفرخ فيه لا يزال ناقس البدن، قليل الفظنة، يلقي ريشه في السنة مرتين فيضعف.وأما المكان فقد حكي عن إقليمن الهندي: أن أولى ما أفرخ الحمام بالسطوح. وذلك أن الفرخ يخرج من القشر فيلقى خشونة الهواء وحر الموضع فيصير له عادة ثم لا ينهض حتى يعرف وطنه وينقلب إليه أبوه وأمه بالزق والعلف فيعرف السطح حق المعرفة، وينتقل خلفهما فيعلمانه الصعود والهبوط، وربما أخذه إلى الرعي بالصحراء فلا يكمل حتى يصير شهماً عارفاً بأمور الطيران؛ بخلاف ما إذا أفرخ بالسفل فإنه يتربى جسده على برودة الفيء ولين الهواء، فإذا كمل وترقى إلى السطح لقيه خشونة الهواء وقوة الحر، فيحدث له الحر الجامد بفؤاده الكباد والدق.؟؟الأمر السابع في مسافة الطيران قد تقدم أن طائراً من الخليج القسطنطيني إلى البصرة، وأن الحمام كان يرسل من مصر إلى البصرة أيضاً.وذكر ابن سعيد في كتابه جنى المحل وجنى النحل: أن العزيز ثاني خلفاء الفاطميين بمصر ذكر لوزيره يعقوب بن كلس أنه ما رأى القراصية البعلبكية، وأنه يحب أن يراها، وكان بدمشق حمام من مصر وبمصر حمام من الشام، فكتب الوزير بطاقة يأمر فيها من بدمشق أن يجمع ما بها من الحمام المصري ويعلق في كل طائر حبابتٍ من القراصية البعلبكية وترسل ففعل ذلك؛ فلم يمض النهار إلا وعنده قدر كثير من القراصية، فطلع بها إلى العزيز من يومه؛ وذكر أيضاً في كتابه المغرب في أخبار المغرب: أن الوزير اليازوري المغربي وزير المستنصر الفاطمي وجه الحمام من مدينة تونس من إفريقية من بلاد المغرب إلى مصر فجاء إلى مصر.وقد ذكر أبوالحسن القواس في كتابه في الحمام: أن حماماً طار من عبادان إلى الكوفة، وأن حماماً طار من الترناوذ إلى الأبلة ونحو ذلك. وسيأتي الكلام على أبراج الحمام بالديار المصرية في المقالة العاشرة فيما بعد إن شاء الله تعالى.